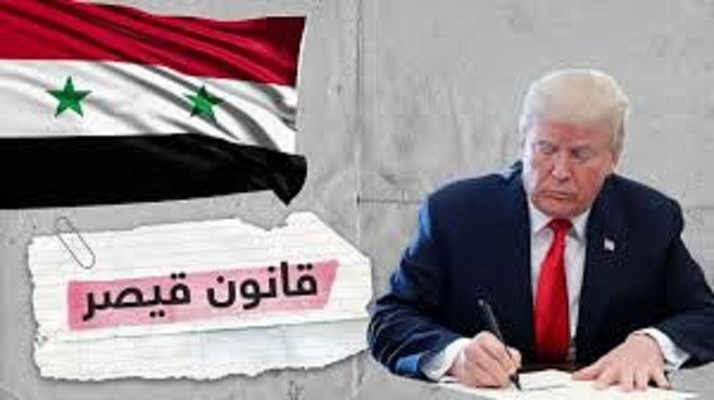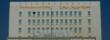عندما وصل وزير الخارجية الأميركية الأسبق كولن باول إلى دمشق بعد غزو واشنطن للعراق عام ٢٠٠٣، رمى أمام الرئيس السوري بشار الأسد سلّة مطالب غربية، أساسها إنسحاب دمشق من "محور المقاومة"، وما يتضمّن ذلك من فك التحالف السوري-الإيراني وطرد مسؤولي حركة "حماس" من الشام، ووقف التعامل مع "حزب الله". يومها رفض الأسد كل الشروط الأميركية، ولم يستجب لأي عنوان، رغم ان معظم عواصم المنطقة كانت ترضخ لأي طلبات أو تمنيات أميركية من دون نقاش بعد دخول الأميركيين بعصا غليظة الى العراق.
صمدت دمشق، ثم شاركت بعد ثلاث سنوات في دعم قتال اللبنانيين ضد إسرائيل عام ٢٠٠٦، ولم يأبه السوريون للتداعيات التي كانت تتراكم غربياً بحق سوريا. وبعد بضعة أعوام حلّت الأزمة السورية سنة ٢٠١١، وتدرّجت فيها المحطات من شعارات "سلمية"، إلى خطوات دبلوماسية، إلى مشاكل أمنية، إلى مواجهات عسكرية، لكن الأسد بقي ثابتاً، خصوصاً ان حلفاءه، تحديداً: الروس والصينيين والإيرانيين رسّخوا صمود سوريا في كل المراحل، عسكريا وسياسيا ودبلوماسياً.
ماذا بعد؟ حلّ العنوان الإقتصادي كمدخل لإخضاع كل السوريين للضغط على دمشق وإجبار الأسد على القبول بذات الشروط التي طرحها كولن باول عام ٢٠٠٣. لم تتغير العناوين الأميركية. بقيت هي ذاتها مطروحة تحت الطاولة، ليأتي قانون "قيصر"، ويشكّل عملياً دافعاً لتطبيق الشروط الأميركية في دمشق، تتضمّن في جوهرها طلب التخلي عن "محور المقاومة" وعدم بقاء الإيرانيين و"حزب الله" على الأراضي السورية.
ما قاله المبعوث الأميركي لدى دمشق جيمس جيفري واضح: المطلوب ان يبدّل النظام السوري سلوكه، ولا نطالب بتغيير النظام. يعني هذا الكلام ان السلوك المرتجى أميركياً هو أن يرضخ الأسد لعناوين المرحلة الجديدة التي تتقدمها صفقة القرن. خصوصاً أن القانون المذكور يشير الى إنفتاح مطلوب من سوريا لفتح صفحة جديدة مع الإسرائيليين. يريدون من دمشق أن تلتزم بتوقيع اتفاقيات مع تل أبيب على غرار ما فعلته دول عربية. يعتقد الأميركيون أن السوريين سيضطرون لقبول الشروط الأميركية، لأن العقوبات ستؤدي إلى تجويع الشعب السوري. ومن هنا جاءت الحرب على الليرة السورية لتأمين شروط اللعبة الإقتصادية، ثم منع الدول والشركات من التعامل مع دمشق تحت طائلة عقوبات "قيصر".
لكن سوريا التي واجهت كل أنواع العقوبات والحصار والحروب في محطات عدة من تاريخها، ولا سيما في أعوام الثمانينات، هل هي مضطرة الآن للبقاء في خيارها الوطني-القومي؟ أم أن مغادرة محورها الممانع هو الأفضل لسوريا؟ اذا تخلت دمشق عن فلسطين سيدفع العرب والفلسطينيون اثمانا باهظة. وإذا طلّقت سوريا حلفها الإستراتيجي مع "محور المقاومة" ستصبح أضعف إلى حد تهديد وحدتها. مما يعني ان إرتباط دمشق بثوابتها الحالية هي ذات أبعاد وجودية. في حال غادرت سوريا مكانها السياسي فمن يضمن عدم تقسيمها وضربها وإبقاء شعبها في دورة الأزمة المفتوحة؟ هل ارتاحت الدول العربية التي وقّعت "اتفاقيات سلام" من أزماتها الإقتصادية؟ لا مصر ولا الأردن ولا السلطة الفلسطينية يعيشون الفرج الإقتصادي ولا الإرتياح المالي.
في أحد أوجه قانون "قيصر" يصوّب الأميركيون على الروس والصينيين الذين يتعاملون مع دمشق، ويتحضّرون لإجراء استثمارات في سوريا. مما يعني ان موسكو وبكين معنيّتان بمواجهة "قيصرية"مع الاميركيين. بالنسبة الى دمشق لن تزيد إجراءات "قيصر" عقوبات عما فُرض عليها. لكن العقوبات الجديدة تأتي لمعاقبة الشركات الروسية والصينية. بالتأكيد لن ترضخ لا موسكو ولا بكين. مما يرجّح ان يكون للعقوبات صدى في بداية تنفيذ القانون، ثم يتدرّج المسار نحو التعايش معها أو الالتفاف عليها.
يمكن لدمشق ان تتباهى بقدرة الرئيس السوري على إبقاء المبادرة بين يديه، ضمن اللعبة الجارية، وتتباهى ايضا بقدرة مصرفها المركزي على إعادة امساك وضع الليرة قبل ان تنزلق الى هاوية شارفت الليرة اللبنانية للوصول اليها. صحيح ان الليرة السورية تراجعت قيمتها في الاشهر الماضية، لكن لولا اجراءات مصرفها المركزي كانت ستتوسّع مساحات الضعف والارباك.
لا تعفي الأزمات الاقتصادية الروسية والايرانية والصينية عواصمهم من مؤازرة سوريا اقتصادياً، وبالتالي فإن طهران التي اوصلت النفط الى فنزويلا قادرة على إيصال معونات الى سوريا. فهل تقدم كل من الصين وروسيا على المضي قدماً في دعم صمود السوريين؟ طبيعة التحالف السياسي والشعبي، ونوعية المواجهة الدولية تفرض عليهما الوقوف الى جانب سوريا. هذا ما هو منتظر منهما سراً او علناً. لأن المواجهة قائمة قيصرياً بين موسكو وواشنطن في دمشق، ولا يمكن ان تتخلى روسيا لا عن سوريا ولا عن مكاسب موسكو في المشرق العربي بعد كل هذه التضحيات العسكرية والسياسية في سوريا.